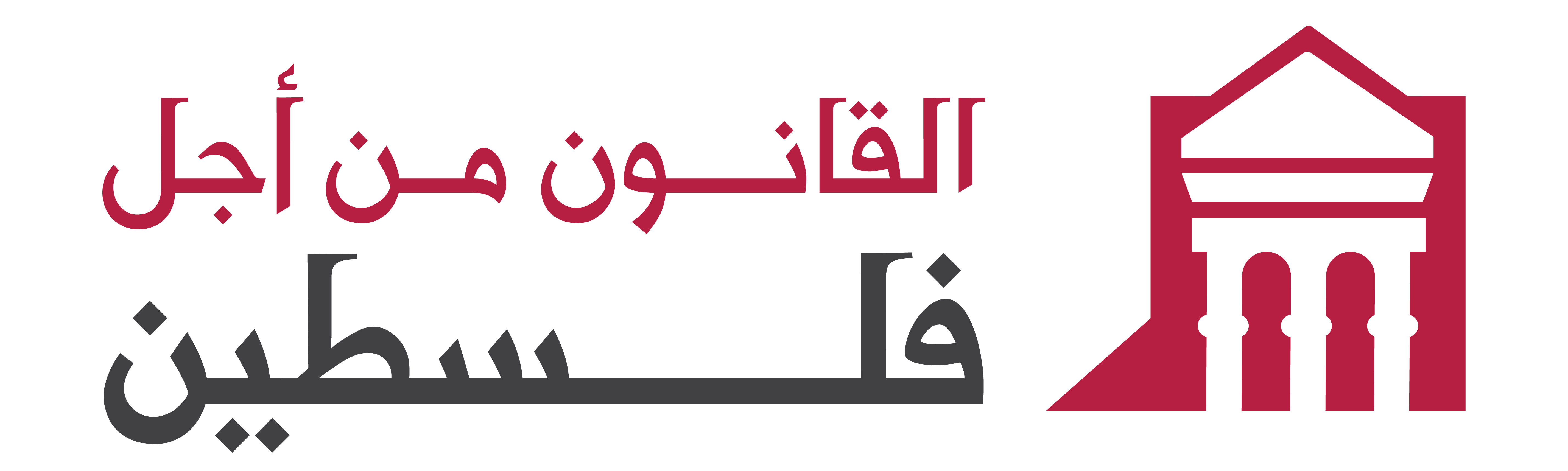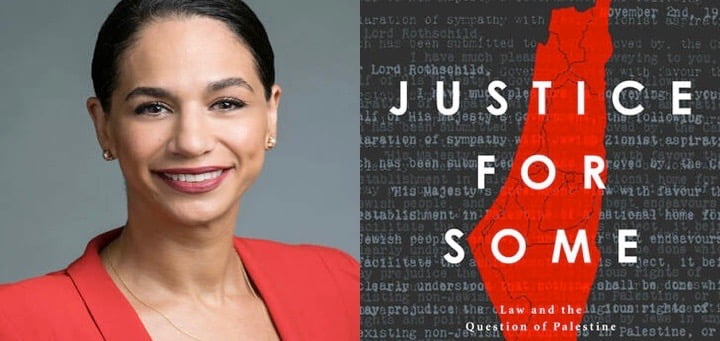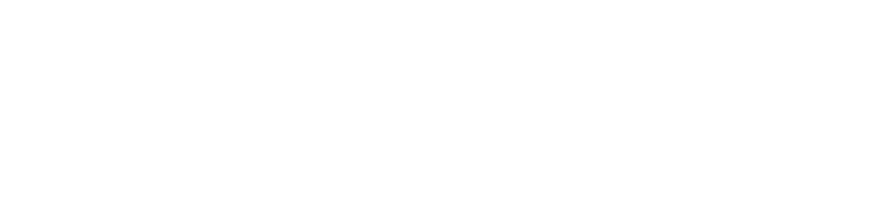عرض كتاب العدالة للبعض – لِ: نورة عريقات
الكاتب: حسان عمران*
ل: القانون من أجل فلسطين
عرض كتاب “العدالة للبعض” لنورة عريقات
معلومات الكتاب
العنوان: العدالة للبعض: القانون والمسألة الفلسطينية
Justice for Some: Law and the Question of Palestine
لغة الكتاب: الإنجليزية
المؤلفة: نورة عريقات، وهي باحثة قانونية فلسطينية أمريكية في مجال حقوق الإنسان، وأستاذة مساعدة في جامعة جورج مايسون في مادة الدراسات القانونية والدولية.
الناشر: مطبوعات جامعة ستانفودر
سنة النشر: 2019
عدد الصفحات: 331 صفحة
مضى أكثر من سبعين عاماً على إعلان قيام إسرائيل وتهجير الشعب الفلسطيني، وأكثر من قرن على سقوط فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي مهّد للحركة الصهيونية، وها هو الشعب الفلسطيني ما زال قابعاً تحت الاحتلال، بلا أرض أو دولة او سيادة او تقرير مصير. وبينما يقف الفلسطينيون بلا سند أو ظهير، تعيش اسرائيل أفضل لحظاتها بدعم أعمى من الولايات المتحدة، القطب الدولي الأوحد، التي حاولت الظهور بمظهر النزيه لعقود إلا أنها -مع وصول ترامب للبيت الابيض- تخلت عن مجرد المظهر وقدّمت خطة لا يمكن وصفها إلا بأنها محاولة إغلاق ملف القضية الفلسطينية للأبد.
وفي ضوء ما سبق، يأتي هذا الكتاب -الذي يحاكي تجربة الكاتبة على مدار 20 عاماً كمحامية دولية وناشطة في اللجنة القانونية في الكونغرس الأمريكي ومحاضرة في القانون الدولي وإحدى مؤسسي موقع جدلية- من أجل نقاش السبب الذي اوصل القضية لهذا لهذا الحال، ولكن من زاوية قانونية، وبطريقة سلسة تتيح لغير المختصين الاطلاع على الكتاب والاستفادة من خلاصته. ولعل هذا الكتاب يأتي في وقت مناسب في ضوء توجه النائبة العامّة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة في الاراضي الفلسطينية المحتلة -وإن كانت الكاتبة غير متفائلة حوله. والكتاب يشكل إضافة مهمة للنقاش الدائر في الولايات المتحدة حول محاولات تسييس القضاء والضغط عليه. ويقع الكتاب في خمسة فصول إضافة للمقدمة والخاتمة، تناقش فيهم الكاتبة أهم المحطات ذات الأثر القانوني في تاريخ الصراع بشكل خطي زمني، بدءا باستعمار فلسطين وصولاً للوقت الراهن.
يقف الكتاب في طرحه بين المثاليين الذين يؤمنون بأن القانون قادر على استرداد الحقوق ورد المظالم، وبين الواقعيين الذين يرون في القانون مجرد نصوص لا قيمة لها في اسوأ الاحوال، أو أدوات يستخدمها القوي لقهر الضعيف. وتناقش الكاتبة قول من يرى أن القانون الدولي -أو المسار الدولي كما يسميه البعض- كفيل بجعل الفلسطينيين يستردون أرضهم -أو جزأ منها على الاقل، وبين من يرى في منطق القانون مجرد استسلام، ويرى أن القانون ليس منصفاً أصلاً. وتذكّر بأن من يسمع اصوات القنابل التي تلقى فوق رؤوس المدنيين في قطاع غزّة، ومن ثم يسمع التبريرات الإسرائيلية المدعمة قانونياً لتلك الأفعال على أنها دفاع عن النفس، يصعب عليه أن يؤمن بأن خيراً سيأتي من ذلك المسار. وتناقش الكاتبة أن الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة فقد الأمل بالمجتمع الدولي وقانونه.
يقف الكتاب في طرحه بين المثاليين الذين يؤمنون بأن القانون قادر على استرداد الحقوق ورد المظالم، وبين الواقعيين الذين يرون في القانون مجرد نصوص لا قيمة لها في اسوأ الاحوال، أو أدوات يستخدمها القوي لقهر الضعيف
ولكن، يتضح في الكتاب موقف الكاتبة التي تقف على مسافة قريبة من الواقعيين، ولكنها ترفض الاستسلام لمنطقهم، وترى في قبوله انهزامية لا تُقبل في حالة الحركات التحررية. فهي أولاً ترى بعدم حيادية القانون -أو على حد تعبيرها الذي كررته طوال الكتاب سواء بالتصريح أو التلميح: “القانون هو السياسة”، ففي النهاية، القانون الدولي هو -بشكل أو بآخر- تقنين لتوازن القوى في فترة ما. وتؤمن الكاتبة بأن القوى الاستعمارية استغلت القانون الدولي -من خلال حجج تقرير المصير للشعوب القابعة تحت الحكم العثماني- من أجل استعمارهم وتمرير أجنداتها الاستعمارية من خلال عصبة الأمم. ولكن الكاتبة ترفض، في نفس الوقت، فكرة أن القانون منحاز بالضرورة، وترى أن الأمر مرتبط بعدة عوامل، أحدها إصرار قوى التحرر وسعيها الدؤوب لنيل حقوق شعوبها وجعل القانون يعترف بها؛ ومنها الحالة الفلسطينية التي أجبرت بريطانيا على استصدار الكتاب الابيض بعد الثورة الكبرى (1936-1939) وكذلك الاعتراف بمنظمة التحرير دولياً ومثولها أمام الأمم المتحدة عام 1974، وغيرها.[i]
وبذلك، فإن الكاتبة تبدو واقعية في فهمها للقانون على أنه ليس مادة مستقلة لا تتأثر بالتجاذبات السياسية، وفي نفس الوقت، فهي بنائية في منهجيتها في التعامل معه. وتضرب عدة أمثلة على هذه البنائية، مثل حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، حينما أدت قوة ضغط الشارع ونضال الأمريكان من أصول افريقية -مع حلفائهم- إلى اعتراف القانون الأمريكي بحقوقهم، ووصول رجل منهم لرئاسة البلاد بعدها بقرابة نصف قرن، وهو الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ورغم أنها تؤمن بعدم انتهاء حركة الحقوق المدنية بعد، إلا أنها ترى أنها تحقق تقدماً يوماً بعد يوم. والمثال الآخر هو نجاح منظمة التحرير الفلسطينية في نيل الاعتراف الدولي ومخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 لتكون أول جهة رسمية غير حكومية تخاطب الجمعية العامة في تاريخها.
ولكن الكاتبة، في نفس الوقت، تذكّر بالأمثلة العديدة الأخرى التي لم يسعف القانون فيها أصحاب الحق لأسباب لا يمكن فهمها إلا سياسياً. وضربت مثالا على ذلك في قضية رفعها عدد من المحامين مطلع القرن الحالي أمام محكمة نيويورك ضد “يعالون”، زير الدفاع الأسبق في الحكومة الإسرائيلية، و”ديختر” وزير الأمن الداخلي ومدير الشاباك السابق، وذلك بعدما استوفوا -بطريقة إعجازية- شروط المقبولية لدى المحكمة. فما كان من المحكمة إلا أن أسقطت القضية بحجّة أنها غير قابلة للتقاضي (Non-Justiciable) -أي أن المحكمة ليست الجهة المناسبة للبت في المسألة، آخذة في الاعتبار أن يعالون وديختر يتمتعان بالحصانة-. إلا أن المفاجئ كان -بحسب الكاتبة- أن نفس المحكمة قبلت لاحقاً قضايا مماثلة ضد مسؤولين صينيين وفلبينيين وصرب، وغيرهم، رغم أنهم كانوا يتمتعون بالحصانة كذلك. كما ضربت الكاتبة أمثلة عديدة -من وحي تجربتها كمحامية وناشطة في اللجنة القانونية في الكونغرس الامريكي- تدل على أنه حينما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن هناك عوامل سياسية تتدخل وتمنع العدالة من أن تأخذ مجراها. وتخلص من ذلك كله إلى أن السياسة هي من رسمت تلك الصورة، لا القانون. وتكرر مقولتها بأن القانون هو السياسة.
وتتحدث الكاتبة “نورة عريقات” عن إشكاليات متعلقة بالقانون الدولي نفسه، تتعلق بجدلية التطبيق. فالقانون الدولي ليس كالقانون المحلي، فلا يوجد محكمة مركزية عليا ولا يوجد شرطة دولية تضمن تنفيذ أحكامه. ففي النهاية، يعتمد القانون الدولي على الالتزام الطوعي للدول. ولكن في نفس الوقت، فإن أحداً ليس بإمكانه التقليل من الضغط الذي يسببه القانون الدولي على الدول، وهذا ما يفسّر تسخير إسرائيل لقدرات هائلة من أجل تبرير موقفها قانونياً، بل والتلاعب بالقانون لإثبات روايتها؛ وهو أمر ترى الكاتبة أن إسرائيل قد نجحت به الى حد كبير طوال العقود السابقة.
بين وعد بلفور وقيام إسرائيل
بِطَريقة خطية زمنية، تبدأ الكاتبة في نقاش كيف استُخدم القانون من قبل القوى العظمى لتمرير أجندتها على الشعوب المقهورة، وكيف تم استخدام عصبة الامم كأداة لذلك. وفي هذا السياق، تتحدث الكاتبة عن وعد بلفور، الذي لا أساس قانوني له بأي شكل من الأشكال، إلا أنه أصبحه مستنداً قانونياً سارياً بالقوة بعدما فرضته بريطانيا على الفلسطينيين من خلال إدراجه في صك الانتداب، رغم مخالفته لميثاق عصبة الأمم.
ولكنها تَسُوق في نفس الوقت أمثلةً لنجاح النضال الفلسطيني -وتحديداً الثورة الكبرى في الثلاثينيات- في إجبار بريطانيا العظمى على الاعتراف بحقوقهم وإصدار وثيقة قانونية يفترض أنها ملزمة قانونا للحكومة البريطانية، تعلن فيها إيقاف الهجرة اليهودية وتأسيس دولة فلسطينية لكل من فيها، تحت مسمى “الكتاب الأبيض”.
احتلال دائم؟
ومع احتلال بقية فلسطين بعد حرب حزيران 1967، تناقش الكاتبة كيف أن القانون نفسه هو من ساعد إسرائيل على شرعنة احتلالها، حيث ترى أن القانون أعطى الفرصة لذلك من خلال البنود المتعلقة بمسؤولية القوة القائمة بالاحتلال عن السكان المحتلين -كما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة-، مما مكّن إسرائيل من تغيير معالم احتلالها ليصبح احتلالاُ دائماً، والإيقاع بالفلسطينيين ليساهموا في شرعنته من حيث لا يدرون، وذلك عبر اتفاقية اوسلو.
ومرت الكاتبة على عدد من القرارات الدولية التي تمكنت إسرائيل من فرض تفسيرها عليها -أو على الاقل جعل المجتمع الدولي ينظر لحججها الواهية قانونيا على انها حجج معتبرة- وتحديداً القرار 242 وحيثية الانسحاب من “كل” الأراضي المحتلة أو “بعضها”. فنص القرار باللغة الانجليزية طالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي احتلت (territories occupied) إثر الحرب، من دون استخدام “الـ” التعريف، بينما استخدم النص الفرنسي -الرسمي ايضا- “الـ” التعريف (des territoires occupés). وهذا التباين أعطى فرصة للمحامين عن إسرائيل بأن يتلاعبوا بمعنى القرار، وتقديم تفسيرهم ليصبح إحدى الرؤى المنظور فيها قانونياً، حيث أنهم اعتبروا أن الانسحاب من الأراضي يشمل صحراء سيناء بدل الضفة وقطاع غزة والجولان. وكان هذا السلوك حاضراً في قرارات أخرى كذلك مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المتعلق باللاجئين، والذي حاولت اسرائيل تخريجه بمظهر إنساني -بعد أن فشلت في إعاقته- من خلال الدعوة لإنشاء صندوق عالمي لمعاونة اللاجئين تساهم إسرائيل في إنشائه ودعمه، وبذلك تتخلص من المسؤولية المباشرة عن اللجوء.
مرت الكاتبة على عدد من القرارات الدولية التي تمكنت إسرائيل من فرض تفسيرها عليها -أو على الاقل جعل المجتمع الدولي ينظر لحججها الواهية قانونيا على انها حجج معتبرة- وتحديداً القرار 242 وحيثية الانسحاب من “كل” الأراضي المحتلة أو “بعضها”
وحينما واجهت إسرائيل انتقادات حادة من حلفائها لضمها شرقي القدس بعد حرب حزيران 1967، حاول سفيرها في الأمم المتحدة “أبا ايبان” تبرير ذلك بالادعاء بأن ذلك لم يكن ضماً (علماً أن الضم دستورياً حصل عام 1980)، وإنما مجرد إجراءات إدارية لضمان سلاسة عمل بلدية القدس. ولكنها لاحقت بعدما اتضحت مسألة الضم، بدأت تلجأ إلى الحجة المذكورة أعلاه حول عمومية النص في القرار 242.
وكعادتها في كل النقاشات حول جدوى القانون، أشارت الكاتبة في المقابل إلى مثال مشرق، وهو نجاح المناضلين الفلسطينيين في نيل الاعتراف الدولي وجعل المجتمع الدولي ينظر إليهم كمقاتلين من أجل الحرية بعد أن كان يراهم عصابات مارقة إرهابية، وذلك تحديداً بعد خطاب عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974، ليكون أول زعيم لكيان دون الدولة يخاطب الجمعية العامّة.
معاهدة فيرساي الفلسطينية!
بدأت عريقات الفصل المتعلق باتفاق اوسلو باقتباس للراحل ادوارد سعيد يصف فيه اتفاق اوسلو باتفاق استسلام فلسطيني، ووصفه بأنه اتفاق “فيرساي” الفلسطيني -رامياً الى اتفاق الاستسلام المهين التي وقعته دول المركز (الامبراطورية الألمانية والنمساوية المجرية والعثمانية ومملكة بلغاريا) بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى.
وتقول الكاتبة إنه منذ السبعينيات، وصولاً لمرحلة ما قبل أوسلو، كان الموقف الدولي يتجه باضطراد نحو الاعتراف بعدالة القضية الفلسطينية وعدالة المطالب الفلسطينية، وجاءت الانتفاضة الاولى لتعطي هذا التوجه زخماً إضافياً. وكان لتزامن بدء انهيار نظام نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا أثر في زيادة ذلك الزخم.
ولكن، مع بدء محادثات مدريد وتوقيع اتفاق اوسلو لاحقاً، بدا وكأن الفلسطينيين بدؤوا في نيل حقوقهم، وبدا لاحقاً أن الصراع هو صراع حول تفاصيل، لا صراع متكامل. وهذا كان جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية التي عملت جاهدة للعثور على ثغرات في النصوص القانونية؛ تحديداً حيثية “الـ” التعريف الآنف ذكرها في القرار 242، وبدأت في الترويج لفكرة البحث عن “حلول عملية”، ومن ثم تقنينها. وهذا ما ورد بصريح العبارة عن المستشار القانوني للجيش الاسرائيلي آنذاك “دانيال ريزنير” والذي قال بان هناك مدرستان لحل الازمات؛ الأولى تقوم على تأسيس القواعد القانونية ومن ثم محاولة تطبيقها، والثانية هي البحث عن الحلول “العملية” ومن ثم بعد الاتفاق عليها إدراجها في القانون الدولي عبر توقيع الاتفاق. ولعل هذا يوضح الفلسفة الإسرائيلية القائمة على فرض الأمر الواقع ومن ثم محاولة نيل الاعتراف الدولي به وفرضه على الفلسطينيين ليصبح قانوناً، بدل التفاوض مع الفلسطينيين من منطلق الحقوق. وكان هذا ما صرّح به وزير الخارجية الأمريكي “جيمس بيكر”، بقوله إن على الفلسطينيين تجنب نقاش القانون إن أرادوا التوصل إلى حل. وختاماً، تم توقيع الاتفاقية بمقايضة الاعتراف بمنظمة التحرير بالاستقلال الفلسطيني -على حد تعبير الكاتبة.
ولكن الكاتبة حاولت بعد ذلك شرح لماذا اتجه الفلسطينيون نحو هذا الاتفاق وهم يعلمون سوءه! حيث تقول إن الكل كان يعلم سوء أوسلو، فلماذا اتجه الفلسطينيون له!؟ وتتحدث هنا عن الضغط الدولي والظروف الإقليمية التي جعلت منظمة التحرير تخضع وتوقع اتفاقاً أثبت بعد 25 عاماً أنه لم يكن لينجح أصلاً -إن افترضنا إمكانية استخدام مصطلح “النجاح” في حالته. فالنظام الإقليمي العربي كان تلقّى ضربة لم يشفَ منها إلى الآن بغزو العراق للكويت، والغزو الأمريكي للعراق بعدها، مما أدى لخسارة العراق بعد خسارة مصر بتوقيعها اتفاقية كامب ديفيد، واختل النظام الدولي بتفكك الاتحاد السوفييتي الذي أعطى لمنظمة التحرير هامشاً للمناورة. ورغم الزخم الناتج عن الانتفاضة الأولى، إلا أنها أشعرت المنظمة بأنها أصبحت “خارج اللعبة”، مما أفقدها القدرة على استثمارها بالشكل الصحيح.
وخلصت الكاتبة إلى أن هذه الاتفاقية -التي أصبحت أساسا قانونياً- لم تكن إلا وليدة ضغوط سياسية بالدرجة الأولى، قبل أن تكون مستندة على الحقوق الفلسطينية. بل إن إسرائيل أشعرت الفلسطينيين بأن اعترافها بفتات من حقوقهم كان “تنازلاً”. ثم تتساءل بتعجب: كيف أصبح إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي المحتلة “تنازلاً”، رغم أنه من المعلوم بالقانون الدولي بالضرورة أن ذلك واجبُ حتمي على القوة المحتلة!؟
من احتلال الشعب إلى قتاله
ثم تستطرد الكاتبة في الحديث عن كيفية انتقال إسرائيل من احتلال الشعب الفلسطيني إلى الاشتباك معه مباشرة أثناء الانتفاضة الأولى والثانية، واستمرارها في ذلك لغاية اليوم. فبدل أن تقوم بواجباتها تجاه الشعب كقوة قائمة بالاحتلال، نراها تستخدم مصطلحات مثل “الدفاع عن النفس”، رغم أنه مصطلح مرتبط بالعدوان، لا بالاحتلال! فالعدوان هو قيام دولة بإرسال قواتها المسلحة لاجتياح إقليم غير تابع لها من دون وجود سبب مبرر، بينما في الحالة الفلسطينية، فإن إسرائيل هي الطرف المحتل، وقواتها العسكرية متواجدة على إقليم غير تابع لها، فكيف لها أن تدّعي حق “الدفاع عن النفس” في إقليم غير تابع لها!؟ وتستدل الكاتبة من خلال ذلك على كيفية سعي إسرائيل إلى صبغ القانون الدولي بروايتها، وجعل ادعاءاتها مقبولة قانونياً، بحيث أنها تستثمر في الماكنة القانونية لديها بما يمكّنها من إيجاد حجج قانونية -وإنْ من خلال الاعتماد على الآراء الشاذة أو المتساهلة (Permissive) قانونياً- وتروِّج لها من خلال مفاوضيها وسفرائها و”أكاديمييها” ووسائلها الإعلامية، بما يجعل من وجهة نظرها إما النظرة السائدة، أو على أقل تقدير تجعلها نظرة “تستحق أخذها بعين الاعتبار”!
ومن أمثلة ذلك أيضاً استخدام اسرائيل الغريب لمصطلح “نزاع مسلح دون الحرب” (armed conflict short of war) أو “النزاع منخفض الحدّية” (low intensity conflict) لوصف الانتفاضة الفسلطينية، رغم أنه مصطلح عسكري مرتبط بالعمليات العسكرية المحدودة التي تقوم بها الدولة ضد مجموعات مصنفة إرهابياً أو عصابات التهريب والمخدرات، وعادة ما يطلق على النزاعات منخفضة الحدية في الدول الفاشلة والتي ليس فيها نظام سياسي مركزي فعال. ولو افترضنا جدلاً أن هذا المصطلح ينطبق في هذه الحالة، فإنه يفتقد إلى أي اطار قانوني صلب، وليس متعارفاً عليه في نصوص القانون الدولي الإنساني. ولكن الماكينة القانونية الإسرائيلية سعت لتقديمه كتبرير قانوني، وبناء عليه، فإنها لا تعمل الأسرى الفلسطينيين معاملة أسرى الحرب، ولا يتم الاعتراف بهم كقوة شرعية مقاتلة.
استثنائية فلسطينية؟
تحدثت الكاتبة نور عريقات في كتابها أيضا[ii] عن صعوبة العامل الدولي في الحالة الفلسطينية. ففي جميع حالات التحرر، وجدنا حليفاً دولياً لها ينافح عنها، إلا أنه في الحالة الفلسطينية، نكاد لا نجد من يدافع عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن انفسهم وفي استخدام القوة لتقرير مصيرهم -مع أنه أمر مكفول قانونياً في مبادئ القانون الدولي وفي قرارات الجمعية العامة المتكررة. فالفلسطيني إن استخدم السلاح فهو إرهابي من دون نقاش، حتى وإن التزم بقواعد قانون الحرب “القانون الدولي الانساني”.
وهنا، تضرب الكاتبة أمثلة أخرى لحركات تحرر نجحت، وحاولت استقراء أسباب النجاح، منها حالة ناميبيا[iii] والتي دخلت حرباً سماها الناميبيون بحرب التحرير الناميبية، والتي حارب فيها جيش التحرير الشعبي الناميبي القوات الجنوب افريقية التابعة لنظام الفصل العنصري. ورأت الكاتبة أن نجاحها ارتكز على ثلاثة عوامل؛ أولها: رفض الناميبيين للمفاوضات الثنائية مع جنوب افريقيا العنصرية -كونهم الطرف الأضعف- وإصرارهم على أن تكون المفاوضات تحت غطاء الأمم المتحدة. وثانيها: أن الكفاح الناميبي المسلح لم يتوقف حتى آخر لحظة من توقيع الاتفاقية. وثالثها: أن المنظومة الدولية لم تكن منحازة ضدهم -كما هي منحازة ضد الفلسطينيين. وقارنت الكاتبة إصرار الناميبيين على كفاحهم رغم سيرهم في المفاوضات، بالمفاوضات مع الانتداب البريطاني أيام الثورة الكبرى في الثلاثينيات وحتى إصدار الكتاب الابيض، ورأت أنه فور تخلي الفلسطينيين عن الكفاح، سرعان ما تقاعست بريطانيا عن الالتزام بواجباتها.
ما العمل؟
تتساءل الكاتبة أخيراً: هل القانون سيحررنا إذن؟ وترى بأن الجواب لا، إلا أننا أيضاً لا يمكن أن نتحرر من دونه. فالمطلوب في رأيها أن نبحث عن أوراق القوة ونعمل على تفعيل جميع أدوات القانون ونعمل على جعله يتبنى رواية صاحب الحق. وترى أن أول خطوة في ذلك هي الابتعاد عن الولايات المتحدة والبحث عن حليف دولي حقيقي. وتضرب أمثلة للإبداع الفلسطيني الذي وجد حلولا وصنع شيئاً من لا شيء.
وترى أن القانون الدولي ليس مرتبطاً بالمحامين فقط كما يظن الكثيرون. وهي هنا تنتقد الأسلوب الذي تم التوجه به إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بفلسطين، وترى أن المطلوب أن يتم استثمار ذلك إعلامياً لكسب التأييد، لا مجرد الاكتفاء بإرسال محامين في بزّات لكسب القضية. وبينما ترى أن على الفلسطينيين ان لا ينتظروا الكثير من المحكمة الجنائية الدولية، ترى بأنه ليس هناك افتقار إلى محامين فلسطينيين جيدين، إلا أن هناك افتقاراً إلى حركة سياسية قوية للتعريف بدعوتهم القانونية والاستفادة من مكاسبهم التكتيكية.
الختام
“العدالة للبعض” هو إضافة لا بد منها للمكتبة الفلسطينية، وتأريخ قانوني نادر للصراع من وجهة نظر فلسطينية، بلغة مزدحمة بالكتابات المصبوغة بالرواية الاسرائيلية. وهو في نفس الوقت، عبارة عن خلاصة قانونية يستفاد منها في دراسة علاقة السياسة بالقانون عموماً، وفي كيفية أن القانون لا ينمو في فراغ وإنما في بيئة تتجاذبها المصالح السياسية.
القانون الدولي، على علّاته، مثّل رادعا دون شك للكثير من الانتهاكات الكبرى التي كانت يمكن أن تحدث بصورة أكبر
وبالتأكيد يمكن الاختلاف مع الكاتبة في بعض ما ذهبت إليه، فالقانون الدولي، على علّاته، مثّل رادعا دون شك للكثير من الانتهاكات الكبرى التي كانت يمكن أن تحدث بصورة أكبر، ومما لا شك فيه، أن توقف إسرائيل عند حدود ما فيما يتعلق بحروبها على غزة في الأعوام 2009 و 2012 و2014، كان من أسبابه اعتبارات لها علاقة بمدى التدمير الممكن “والذي يمكن القبول به” دوليا. كما أن السياق الحالي للقضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، والتسريبات عن قيام إسرائيل بإعداد قائمة بأسماء المسؤولين الذين يمكن أن يتعرضوا للمحاكمة أمام المحكمة، والملفات المتكررة التي تعدها إسرائيل لتبرير حروبها وانتهاكاتها للقانون الدولي، كلها مؤشرات تدلل على حجم التحدي الذي يمثله القانون في هذا المضمار. نقول ذلك مع الإقرار المؤكد بأن “القانون هو السياسة” كما تفضلت الكاتبة، وبأن ميزان القوى يلعب دوراً مهما في هذا المجال، لكن ميزان القوى ذلك لا يمكنه أبدا أن يبرر جريمة حرب ثابتة، أو أن يبرر الاحتلال كفعل قانوني.
وبالعموم، يأتي هذا الكتاب الذي كتبته محامية وأكاديمية ذات تجربة عملية كبيرة واطلاع أكاديمي كبير، ليؤكد أن الفلسطينيين يحتاجون إلى أن يجتهدوا في سبيل تفعيل الأدوات القانونية، وصبغ القانون الدولي بروايتهم المستندة على الحقوق، وأن لا يتروكوا الامر سائغاً لإسرائيل ومحامييها ليتلاعبوا بالقانون على هواهم. القانون -كما تراه نورة عريقات في “العدالة للبعض”- لا يكفي لتحقيق العدالة، فهو يعمل في بيئة سياسية يسيطر فيها القوي على الضعيف، ولكن صاحب الحق مطالب بأن يبذل وسعه لفرض حقوقه على القانون.
—
[i] شددت الكاتبة على هذه الفكرة في خاتمة الكتاب، وضربت الامثلة الذكورة في هذا السياق حول النضال الفلسطيني وكيف اثر على القانون
[ii] تحدثت الكاتبة باستفاضة حول هذه النقطة الاساسية في الكتاب والعديد من محاضراتها وكتاباتها، وهي صعوبة العامل الدولي وكونه متعارض مع المصلحة الفلسطينية.
[iii] تحدثت الكاتبة عن الحالة الناميبية عدة مرات في الكتاب، إلا ان التحليل على النسق المذكور هنا كان في محاضرة إطلاق كتابها.

* حسان عمران كاتب وناشط قانوني حاصل على ماجستير في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وهو يكتب بانتظام لعدة منصات كتابية حول القضايا المتعلقة بالقانون الدولي والسياسة الدولية، كما أنه مؤلف مشارك لكتاب، وسيقوم بنشر كتابٍ آخر قريبًا. لمتابعة أعماله ووجهات نظره، يمكن متابعة صفحته على Twitter