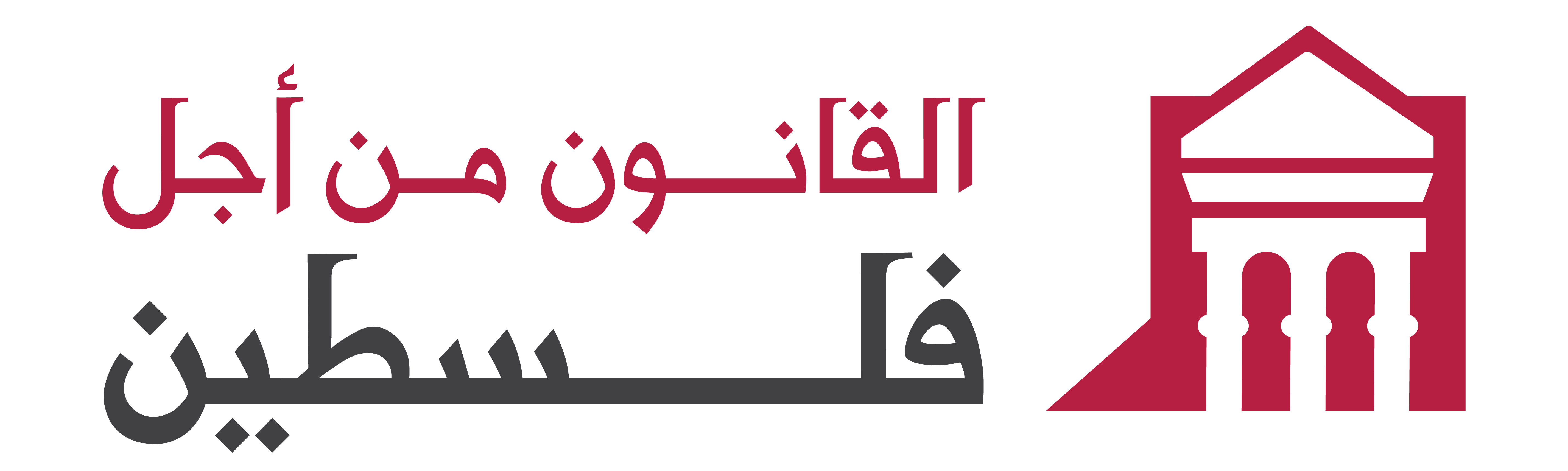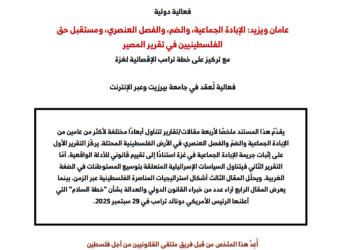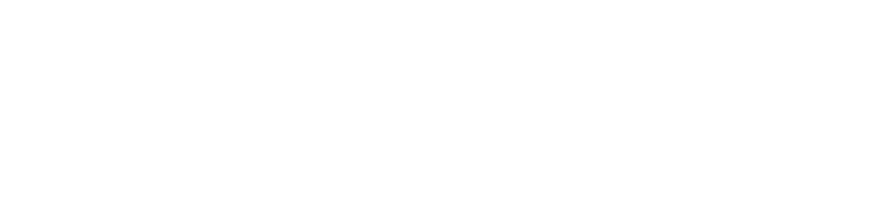خارج سياق البيئة: كيف تعزز فتوى محكمة العدل الدولية بشأن المناخ السبل القانونية للمساءلة في فلسطين
المؤلف: بيرس كلانسي
زميل ما بعد الدكتوراه – كلية الحقوق، كلية ترينيتي في دبلن. وزميل مؤسسة NUI EJ Phelan في القانون الدولي (2022–2024)
في 23 يوليو/تموز 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) فتواها الاستشارية بشأن “التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ”. وتركز هذه الفتوى في المقام الأول على قضايا القانون الدولي البيئي وقانون تغير المناخ الدولي. ومع ذلك، وبعيدًا عن التهديد العالمي الناجم عن تدهور المناخ وانهياره، فإن عناصر من التحليل القانوني الوارد في الفتوى تكتسب أهمية مباشرة فيما يتعلق بفلسطين والإبادة الجماعية المستمرة التي تُفرض على الشعب الفلسطيني. تهدف هذه المقالة القصيرة إلى تحديد ثلاثة من هذه العناصر واستعراض كيف يمكن استخدامها في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة لفلسطين من خلال القانون الدولي.
النزاع المسلح وتغير المناخ
في مرافعاتها الشفوية أمام المحكمة بخصوص الفتوى الاستشارية، أولت دولة فلسطين اهتمامًا كبيرًا للعلاقة بين النزاع المسلح وتدهور البيئة، وكذلك للحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للبيئة الطبيعية. وفي هذا السياق، عرضت الأستاذة نيلوفر أورال، بصفتها محامية لدولة فلسطين، القواعد ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني التي توفر حماية للبيئة، ودعت المحكمة إلى إصدار:
“… توجيهات واضحة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأضرار الناتجة عن تغير المناخ بسبب النزاع المسلح وغيره من الأنشطة العسكرية. ونطلب على وجه الخصوص أن توضح المحكمة أن البيئة، بما في ذلك مصارف ومخزونات الكربون، تُعد من الأعيان المدنية، وأن قواعد التمييز والتناسب والاحتياط تنطبق على النزاع المسلح والأنشطة العسكرية الأخرى التي تُنتج انبعاثات غازات الدفيئة وتُسهم في تغير المناخ.”
كما شددت كيت ماكنتوش، وهي أيضًا محامية عن دولة فلسطين، على وجود فجوة كبيرة في الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة خلال النزاعات المسلحة، بما في ذلك حالات الاحتلال. فإسرائيل، على سبيل المثال، لا تُدرج انبعاثاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء الناتجة عن الإبادة الجماعية في غزة أو عن مشروع الاستيطان غير القانوني، ضمن تقاريرها الخاصة بالانبعاثات، كما أنها لا توثق تدمير مصارف الكربون.
ومع ذلك، لم تتطرق المحكمة إلى مسألة النزاع المسلح في الفتوى نفسها، حيث لم يرد ذكر النزاع المسلح سوى في الإعلان المنفصل الصادر عن القاضية كليفلاند، التي أكدت فيه أن على الدول التزامًا بـ”تقييم الأضرار التي تلحق بالنظام المناخي نتيجة النزاعات المسلحة وغيرها من الأنشطة العسكرية، والإبلاغ عنها والحد منها.”
واجب المنع (الإبادة الجماعية)
تُعد مسألة “واجب المنع” من النقاط ذات الأهمية البالغة في النقاشات القانونية المتعلقة بالتزامات الدول الثالثة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية الجارية في غزة. وقد تناولت محكمة العدل الدولية هذا الواجب لأول مرة في حكمها الصادر عام 2007 في قضية البوسنة ضد صربيا، حيث أشارت إلى أن الواجب يتطلب من الدول “استخدام جميع الوسائل المتاحة والمعقولة لمنع وقوع الإبادة الجماعية قدر الإمكان.”
كما أوضحت المحكمة أن هذا الواجب يفرض على الدول التصرف على أساس العناية الواجبة، مع الإشارة إلى أن الدول التي تمتلك قدرة أكبر على التأثير في الأطراف المعنية بالإبادة تتحمل مسؤولية أكبر.
ويُقابل هذا الواجب في القانون الدولي البيئي واجب مماثل يُعرف بـ”واجب منع الضرر البيئي الجسيم”. ورغم أن المحكمة تناولت هذا الواجب سابقًا في حكمها في قضية “مصانع اللب”، فإنها لم تقارنه مباشرةً بواجب منع الإبادة الجماعية. لكن في الفتوى الأخيرة، تربط المحكمة بشكل مباشر بين الواجبين، إذ توظف الصيغة المستخدمة في قضية البوسنة ضد صربيا (الفقرة 132-139) لتوضيح طبيعة العناية الواجبة في مجال البيئة. وهذا أمر مهم، لأن المحكمة كانت حريصة آنذاك (الفقرة 429) على التأكيد بأنها لا تضع تصورًا عامًا لواجب المنع، بل تتحدث فقط عن سياق اتفاقية الإبادة الجماعية. ولذلك، فإن استناد المحكمة اليوم إلى واجب منع الإبادة كمرجع للواجب البيئي، يُشير ضمنًا إلى أن منهجية أحد الواجبين قد تنطبق على الآخر.
وفي الفقرة 428 من الفتوى، تؤكد المحكمة نقطة مهمة تتعلق بواجب المنع والجهات الخاصة، مثل الشركات، التي تعمل أو تتواجد في أراضي الدولة. حيث تقول المحكمة:
“فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الخاصة، ترى المحكمة أن الالتزامات التي حددتها بموجب السؤال (أ) تشمل التزام الدول بتنظيم أنشطة الجهات الفاعلة الخاصة وفقًا لمبدأ العناية الواجبة… وبالتالي، قد تتحمل الدولة المسؤولية إذا تقاعست، على سبيل المثال، عن اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة للحد من الانبعاثات الناتجة عن الجهات الفاعلة الخاصة الخاضعة لولايتها.”
بالإضافة إلى نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تتطلب عمومًا موافقة الدولة من خلال تراخيص التصدير، قد تنتهك الدول واجب المنع من خلال السماح، على سبيل المثال، بانضمام رعاياها إلى الجيش الإسرائيلي، أو المشاركة في برنامج “سندات إسرائيل”
وفي سياق غزة، يتضح أن واجب منع الإبادة الجماعية يتطلب التزامًا بالعناية الواجبة لضمان عدم مساهمة الشركات والجهات الأخرى في ارتكاب الإبادة. وبالإضافة إلى نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تتطلب عمومًا موافقة الدولة من خلال تراخيص التصدير، قد تنتهك الدول واجب المنع من خلال السماح، على سبيل المثال، بانضمام رعاياها إلى الجيش الإسرائيلي، أو المشاركة في برنامج “سندات إسرائيل”، أو السماح للمؤسسات المالية داخل أراضيها بتقديم الدعم المالي للجهات الإسرائيلية المشاركة في الإبادة. ويُعد هذا التحول من التركيز على الأفعال الإيجابية (مثل إصدار التراخيص) إلى الأفعال السلبية (مثل التقاعس عن تنظيم أنشطة الجهات الخاصة) تطورًا مهمًا يجب أن تأخذه الدول الثالثة بعين الاعتبار في علاقاتها مع إسرائيل.
وعلى نحو ذي صلة، ورغم أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 لا تحتوي على صيغة مماثلة لـ “واجب المنع”، فإن المادة الأولى المشتركة تُلزم الأطراف السامية المتعاقدة بـ “ضمان احترام” القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات لحث الدول الأخرى على الامتثال له. وعند تطبيق متطلبات العناية الواجبة الخاصة بواجب المنع على هذا الواجب، يُستنتج أن على الدول أيضًا التأكد من أن الجهات الخاصة الواقعة تحت ولايتها لا تُساهم في انتهاك القانون الدولي الإنساني، مثل تقديم مواد بناء تُستخدم في إنشاء وصيانة المستوطنات الإسرائيلية.
صفة التقاضي من قبل طرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية
النقطة الأخيرة الجديرة بالذكر هي أن المحكمة، في فتواها الاستشارية، اعترفت بإمكانية قيام الدول برفع دعاوى أمامها استنادًا إلى الالتزامات الدولية التي تُلزم أي دولة تجاه الجميع (erga omnes)، والتي تختلف عن الالتزامات التي تُلزم الدول تجاه الأطراف الموقعة على اتفاقية معينة فقط (erga omnes partes) – انظر الفقرات 441–444؛ وراجع أيضًا Paddeu وJackson. وقد استندت قضايا سابقة رفعتها دول غير متضررة – مثل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ونيكاراغوا ضد ألمانيا (بشأن الدعم الألماني لإسرائيل أثناء الإبادة الجماعية) – إلى النوع الثاني من الالتزامات المرتبطة بالمعاهدات متعددة الأطراف. ولا يمكن رفع هذا النوع من القضايا ضد الدول التي قدمت تحفظات على بنود الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية في معاهدات مثل اتفاقية الإبادة الجماعية. وبما أن هذه التحفظات باقية على الأرجح، فإن إمكانية رفع قضايا استنادًا إلى الالتزامات تجاه الجميع erga omnes القائمة على القانون الدولي العرفي أو القواعد الآمرة (jus cogens) قد تفتح آفاقًا قانونية جديدة للدول الساعية للمساءلة.
ومع ذلك، لا تزال هذه القضايا بحاجة إلى الامتثال لنظام الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية، ولا يمكن رفعها إلا ضد دول قبلت الاختصاص القضائي الإلزامي للمحكمة. إسرائيل لم تقبل هذا الاختصاص، والولايات المتحدة سحبت قبولها له في ثمانينيات القرن الماضي. ومع ذلك، فإن العديد من الدول الغربية التي قبلت اختصاص المحكمة قد تكون، من خلال دعمها المستمر لإسرائيل، متواطئة في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو الحق الذي اعترفت به المحكمة في فتواها الاستشارية في يوليو/تموز 2024 كقاعدة من قواعد jus cogens وذات صبغة إلزامية تجاه الجميع.
وعلى الرغم من حرية الدول في فرض قيود على اختصاص المحكمة عليها، فإنه يمكن استخدام تأكيد المحكمة على صفة الالتزام تجاه الجميع كأساس قانوني لرفع مزيد من القضايا ذات المصلحة العامة أمام المحكمة. ويُشير اعتراف المحكمة بإمكانية رفع مثل هذه القضايا إلى انفتاحها على استخدام اختصاصها بهذا الشكل.
الخلاصة
كما ذُكر في البداية، لا تهدف هذه المقالة إلى تقديم دراسة شاملة لكافة الدلالات القانونية للفتوى الاستشارية، بل إلى تسليط الضوء على بعض العناصر الرئيسية التي قد تكون ذات قيمة لجهود المساءلة المتعلقة بفلسطين. وتكمن القيمة الأساسية للفتوى، بالطبع، في تناولها للقانون الدولي فيما يتعلق بتغير المناخ، الذي يؤثر على فلسطين كما يؤثر على بقية العالم. ومع ذلك، فإن مساهمتها في تطوير القانون الدولي بشكل أوسع سيكون لها أثر على التقاضي والعمليات القانونية الأخرى المتعلقة بفلسطين.