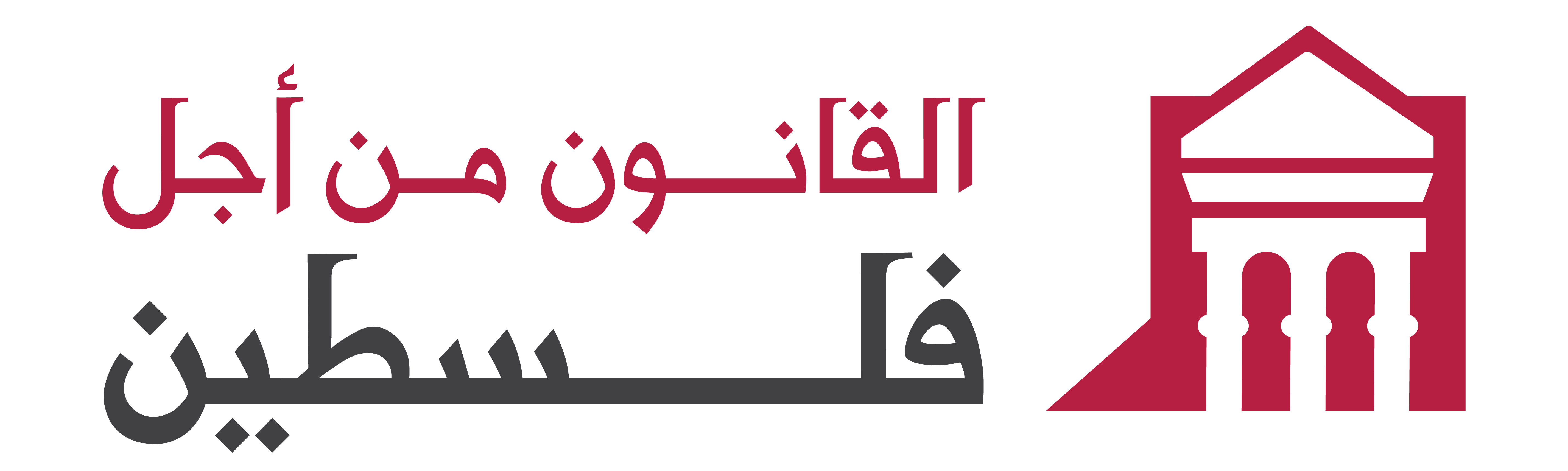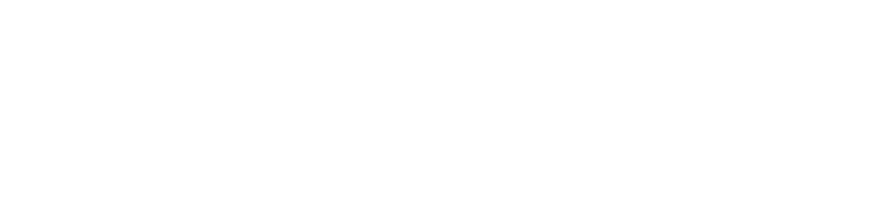كيف تسخّر إسرائيل القانون الدولي للدفاع عن نفسها؟
إعداد: الباحثة مريم جمشيدي: وهي أستاذة مساعدة في القانون في كلية ليفين للقانون بجامعة فلوريدا، حيث تُدرِّس وتكتب في مجالات الأمن القومي والقانون الدولي العام وقانون العلاقات الخارجية وقانون التعويضات المدنية. في مقالها هذا تتناول مسألة كيف تسخر إسرائيل القانون الدولي للدفاع عن نفسها.
تم نشر هذا المقال أولا باللغة الإنجليزية في Boston Review. رابط المقال الأصلي هنا
ترجمة إلى العربية: إسراء إبراهيم
تدقيق النسخة العربية: أحمد المصري وهبة بعيرات
ل: القانون من أجل فلسطين ©
تتلاعب إسرائيل بقواعد الاشتباك لخدمة مشروعها الاستعماري في فلسطين. هذا ما ينبغي على الفقهاء القانونيين التصدي له من الآن فصاعداً.
تبدأ الكاتبة جمشيدي مقالها حول كيف تسخر إسرائيل القانون الدولي للدفاع عن نفسها والمنشور في “بوسطن ريفيو” بالإشارة إلى انتقاد الباحثة القانونية ناز مدیرزاده في مقال نشرته مجلة هارفارد للقانون الدولي للنهج المتجرد والنائي لعلماء القانون المعاصرين عند كتابتهم حول قوانين الحرب والنزاعات. حيث تشير مديرزاده، وفقاً للجمشيدي، إلى أن أبحاث هؤلاء العلماء تخلو من تقديرٍ دقيق للسياق السياسي والخلفية التاريخية للأحداث التي يكتبون عنها، والتي في كثير من الأحيان لا تشير إلى الناس، أو إلى تجربتهم في الحرب، أو إلى مسؤولية الآخرين السياسية المتعلقة بظروف الحرب التي مروا بها، ولا إلى إداراكهم الأساسي البسيط لنظرة القانون الدولي لهؤلاء الناس ونهج التعامل معهم. بدلاً من ذلك، تناشد ناز مديرزاده الفقهاء بالبدء بالكتابة بشغف يعكس الموقف الأخلاقي والاستعداد لأخذ الأخلاق المهنية على محمل الجد عند الكتابة عن القانون الدولي والحرب لجمهور القراء أو ذوي السلطة والقادرين على اتخاذ قرارات بشأن الحروب.
ترى جمشيدي أن التحليل القانوني الغربي بمجمله، يتجاهل، عند الحديث عن العنف الإسرائيلي في غزة، تاريخه وبنيانه الاستعماري.
ومن هنا تنطلق جمشيدي لتقول إنها تتمنى في ظل هجوم إسرائيلي آخر ضد الفلسطينيين في غزة، أن يتم اعتبار نظرة مديرزاده عند التحدث عن التوظيف الإسرائيلي العنيف للقانون الدولي، لا من وجهة نظر الفقه المغرق في الحيادية، بل وفقاً للسياق الاستعماري الذي جعل من تكرار إسرائيل لجرائمها في غزة شيئاً ممكناً، بالإضافة إلى اعتداءاتها السافرة على باقي أجزاء “فلسطين التاريخية”.
ترى جمشيدي أن هذا الواقع، على مدار أكثر من سبعين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي، كان واضحًا تماماً للفلسطينيين أنفسهم وللقانونيين الفلسطينيين والإسرائيليين كذلك، خاصةً أن كثيراً من الإسرائيليين يدعمون تلك السياسات. وها قد بدأت هذه النقاشات تشق طريقها نحو الحوارات الإعلامية السائدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية في وسائط الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لا يزال التحليل الغربي القانوني للعنف الإسرائيلي في غزة يتجاهل الخلفية الاستعمارية لإسرائيل وطبيعة المقاومة الفلسطينية المناهضة لهذا الاستعمار. وتقول جمشيدي إنه لا غنى عن فهم هذا السياق الذي يكشف أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتحايل على القانون الدولي حتى تتخلص من مسؤولياتها الإنسانية في غزة ومن مسؤوليتها عن قتل الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع المحاصر.
مهاجمة غزة… مرة أخرى
تشير جمشيدي إلى أنه من الضروري وضع الأزمة الحالية في سياقها الصحيح حتى نفهم ونعي التشوهات القانونية الإسرائيلية وعلاقتها بمشروعها الاستعماري. فعلى مدار المدة الماضية، كان الدافع وراء الهجوم الأخير على غزة [مايو 2021] هو الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة في القدس الشرقية المحتلة. حيث في أبريل، هاجمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، ثالث أكثر الأماكن قدسية في الدين الإسلامي، في أول ليلة من شهر رمضان ومن ثم اقتحمت منطقة باب العامود، التي تعد من أكثر الساحات التي يتجمع فيها الفلسطينيون، بالإضافة إلى تقليص الساحات المحلية التي بوسع الفلسطينيين التجمع بها في مدينة القدس.
وأضافت ان السلطات الإسرائيلية كانت قد انضمت لمجموعات من المستوطنين الإسرائيليين لتهجير العائلات الفلسطينية المقيمة في القدس الشرقية، وتحديداً في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. مشيرة إلى أنه طوال شهر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار، قامت القوات الإسرائيلية بحملة مضايقات ضد هذه العائلات، وقمعت بوحشية الاحتجاجات والاعتصامات التي نُظمت في الشيخ جراح لدعم جهود الفلسطينيين في البقاء في منازلهم. و مع استمرار هذا القمع، صعّدت القوات الإسرائيلية من فعلها الوحشي باضطراد، ابتداءً من 7 مايو/آيار وحتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، من خلال مهاجمة المسجد الأقصى مرة أخرى، حيث أطلقت القنابل الصوتية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، بما في ذلك ضد المصلّين داخل المسجد.
كل هذه الأحداث أثارت وفقاً لجمشيدي احتجاجات تضامنية نظمها الفلسطينيون في مختلف أنحاء فلسطين التاريخية. وعلى الرغم من صعوبة تحديد التاريخ الذي بدأ فيه هذا التضامن، لكن يبدو أن هذه المظاهرات قد انتشرت بشكل كبير في بداية شهر مايو 2021. قام الجيش الإسرائيلي والشرطة بالتعاون مع مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين بالرد على المتظاهرين بممارسة العنف المفرط، بما في ذلك الهجوم على المنازل، وحملة الاعتقالات في الضفة الغربية ومدن أخرى داخل إسرائيل نفسها.
ترى جمشيدي أن الحرب الإسرائيلية طويلة الأمد على غزة تتشابه إلى حدّ كبير مع حروب الاستعمار الأوروبي، بما في ذلك الألاعيب القانونية التي تمارسها إسرائيل لتبرير هجومها على الفلسطينيين.
تشير جمشيدي إلى قيام حماس، التي فازت بالانتخابات السياسية في غزة عام 2006، بتحذير الحكومة الإسرائيلية، مطالبةً إياها بوقف الانتهاكات أو مواجهة رد مسلح من المقاومة. لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية، لذلك في يوم 10 مايو بعد أيام قليلة من التحذير الذي وقع يوم 4 مايو، أطلقت حماس عدد من الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل. وبينما كان يتصدى نظام دفاعها المسمى بالقبة الحديدية لمعظم الصواريخ، كانت إسرائيل تضرب غزة بأسلحتها المتقدمة والحديثة. وتضيف جمشيدي أنه ما أن تم وقف إطلاق النار في 20 مايو، كانت إسرائيل قد قتلت على الأقل 243 فلسطينيا، من بينهم حوالي 66 طفلا، كما تسببت الانتهاكات الإسرائيلية بإصابة ما يقرب من 1900 فلسطيني، وقامت بتهجير وتشريد 90 ألف من المقيمين في غزة، أما عن الصواريخ التي أطلقتها حماس فقد تسببت في قتل 12 إسرائيلي من بينهم طفلين.
ترى جمشيدي أنه حتى الأحداث الأخيرة لا تعبر عن القصة بأكملها، أي الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون. وأنه يتطلب لفهم وإدراك أفعال العنف التي تتم في غزة من قبل إسرائيل الاطلاع بمنظور أوسع حول الاحتلال والاستعمار الذي حوّل المنطقة إلى موقع متطرف لأعمال العنف الإسرائيلي الرسمي.
تقول جمشيدي أنه منذ عام 1967 وبعد حرب ال 6 أيام، صنف المجتمع الدولي إسرائيل على أنها دولة محتلة لغزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الطبيعة الممتدة لهذا الاحتلال بما في ذلك المستوطنات الضخمة في الضفة الغربية، بما فيها الجانب الشرقي من مدينة القدس، فقد بدأ مسؤولو الأمم المتحدة مؤخرًا بالإشارة إلى الوضع القائم على أنه ضمٌّ احتلالي. وتضيف أنه بينما تؤكد إسرائيل أن احتلالها لغزة انتهى مع انسحاب مستوطناتها هناك في عام 2005، ومن الواضح جيداً أن هذا الادّعاء مدحوض بفعل الأحداث غير المعقولة على أرض الواقع، وقد تم رفضه من المجتمع الدولي. مضيفة أن حماس تتمتع بالسلطة السياسية الشكلية داخل غزة، لكن السلطة الفعلية على المنطقة تظل بيد إسرائيل. وفي عام 2007 استكملت إسرائيل احتلالها لغزة من خلال الحصار الاقتصادي والعسكري الذي يتواصل حتى يومنا هذا. كما تسيطر إسرائيل، وفقاً لجمشيدي، على كافة أشكال الحياة للفلسطينين في غزة، والتي تتمثل في الحصول على الطعام، والدواء، وحتى شبكات الكهرباء، بجانب التحكم بالنقل الجوي في غزة، وعلى الأراضي، والحدود البحرية. نتيجة هذا الاحتلال والسيطرة، تمكنت إسرائيل من تحويل غزة إلى سجن شديد الحراسة، ووفقاً لما ورد عن الأمم المتحدة، فقد أصبحت تلك المنطقة غير صالحة للعيش في عام 2020.
تواصل الجمشيدي قولها أنه يسكن في غزة نحو 2 مليون فلسطيني على مساحة 140 ميلاً مربعاً، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. وهذه الكثافة السكانية تأتي نتيجة لكلٍ من الاحتلال والحصار الذي تمارسه إسرائيل، والذي يجعل الانسحاب من المنطقة مستحيلاً، فضلاً عن التطهير العرقي الذي بدأت إسرائيل في تنفيذه منذ عام 1947 – وحرب عام 48. تلك الحرب التي شنتها إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين الأصليين وحلفائهم العرب، كانت تهدف، وفقاً لجمشيدي، إلى تأمين أوسع مساحة من فلسطين التاريخية بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين لتأسيس دولة إسرائيلية مستقبلية. وتضيف أنه كما أوضح المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه أنه، ولتحقيق هذا الهدف، اتبعت إسرائيل سياسة رسمية للتطهير العرقي وتهجير السكان الأصليين. ونتج عن اتباع هذه السياسة تهجير 80% من الفلسطينيين من منازلهم وفضّل الكثيرون منهم اللجوء إلى غزة، التي كانت واقعة تحت السيطرة المصرية بعد الحرب. اليوم، حوالي 1.4 مليون فلسطيني، أي ما يقرب من 70% من عدد السكان في غزة، هم لاجئون أو أحفاد للاجئين شردوا بفعل سياسات التطهير الإسرائيلية.
تؤكد جمشيدي أن الإخضاع الإسرائيلي للفلسطينيين مستمر حتى يومنا هذا. كما وثقت عدة منظمات فلسطينية (تتضمن الحق، وبضعة آخرين)، وإسرائيلية (بتسيلم)، ودولية (هيومن رايتس وواتش) أن إسرائيل اتبعت سياسة الفصل العنصري بشكل ممنهج، بما في ذلك التمييز العنصري ضد الفلسطينيين وتشريدهم في جميع أنحاء فلسطين.
وترى جمشيدي أنه وفقاً لهذه التقارير فقد اتبعت إسرائيل سياسات الإخضاع والتطهير العرقي بشكل مطلق في غزة. في عام 1969، بدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي في النظر لوضع خطة لنقل الفلسطينيين من غزة إلى باراغواي، بينما في عام 1992 تم الإشادة برئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين بوصفه صانع السلام بينما أعلن “أنه يرغب في أن يرى غزة تغرق في البحر”. في عام 2007 أصبح حلم رابين الوحشي هو السياسة المتبعة في إسرائيل وفقاً لجمشيدي. فقد قامت إسرائيل بالإضرار بوضع سكان غزة والتأثير سلباً على صحتهم كجزء من عملية حصار غزة، كما قامت إسرائيل بالتحكم في السعرات الحرارية للمنتجات التي تدخل للفلسطينيين في غزة مما أدى إلى تفشي الكثير من حالات سوء التغذية بصورة مزمنة، بصورة متعمدة كجزء من تلك السياسة. نتيجةً لهذا الحصار، ارتفع معدل الوفيات في غزة 7 أضعاف مقارنةً بالمعدل في إسرائيل. كما منعت السلطات الإسرائيلية بطريقة ممهنجة الأدوية واللوازم الطبية التي تتضمن اللقاح الواقي من فيروس كورونا Covid 19 من الوصول إلى المنطقة، كما منعت الفلسطينيين من التنقل والسفر لتلقي اللقاح أو الرعاية الطبية في أي مكان آخر. وأوردت جمشيدي أنه جاء على لسان طبيب كان يعمل لفترةٍ في غزة أن الوضع القائم فيها من منع اللوازم الطبية والأدوية يزيد من تردي الأوضاع ويصعب من إمكانية حصر والتحكم بالأمراض المعدية والمميتة مما يؤدي بشكل قطعي إلى زيادة حالات الوفاة.
لكن وفقاً لجمشيدي فإن المجازر التي تشنها إسرائيل على نطاق واسع في غزة، وتتضمن الهجوم الحالي وعدة مجازر قامت بها إسرائيل في 2008، و2012، و2014، والتي قد أسفرت عن مقتل الآلاف هو الشاهد الأوضح على تحويل هجوم إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة إلى تطهير عرقي. وتقول أنه بطرق مختلفة تتشابه الحرب القائمة على غزة لفترة طويلة مع الحروب الاستعمارية التي شنتها الدول الأوروبية الاستعمارية في القرن الـ 19، بما في ذلك التلاعب القانوني من قبل إسرائيل ومحاولاتها البهلوانية لتبرير وشرعنة هجومها على الفلسطينيين.
إسرائيل تعيد كتابة قوانين الحرب
ترى جمشيدي أن المنظور التاريخي مهم لفهم الطريقة التي تجنبت بها إسرائيل القانون واستغلته في الوقت نفسه لتسهيل عنفها في غزة. من ناحية، أنكرت إسرائيل أن قانون الاحتلال، وهو فرع من فروع القانون الدولي الإنساني ويتألف من أحكام اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ينطبق على أفعالها في غزة. في الوقت نفسه، اعتمدت إسرائيل على الحجج الاستعمارية حول قوانين الحرب لتبرير أفعالها ضد الفلسطينيين في غزة. من خلال هذه الجهود، حاولت إسرائيل وضع علاقتها بغزة ضمن نموذج حربي يتيح لإسرائيل مرونة أكبر بكثير مما قد يكون لها بموجب قانون الاحتلال؛ وذلك للانخراط في هجمات عسكرية واسعة النطاق.
تضيف جمشيدي أن ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس هو مثال واضح لتلك الديناميكيات. فقد استندت إسرائيل مرارًا وتكرارًا إلى حجة حق الدفاع عن النفس في محاولة لتبرير هجومها الهائل على غزة، حيث تعترف المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بهذا الحق وكذلك القانون الدولي العرفي. يتيح حق الدفاع عن النفس للدولة فعل ما يُحظر القيام به عمومًا ألا وهو إطلاق العنان للقوة العسكرية ضد دولة أخرى.
تؤكد جمشيدي أن هناك عدة مشاكل متعلقة بحجة إسرائيل في حق الدفاع عن النفس فيما يتعلق بعلاقتها بغزة.
تؤكد الجمشيدي أن هناك عدداً من المشاكل في حجة الدفاع عن النفس التي تدعيها إسرائيل فيما يتعلق بغزة. أولاً، كما أكدت محكمة العدل الدولية، فإن حق الدفاع عن النفس ليس سوى حق للدول ضد الدول الأخرى. وقد عارضت إسرائيل والولايات المتحدة هذا الرأي. وبينما يؤيد آخرون موقف محكمة العدل الدولية، لا تزال دول أخرى تتخذ موقفاً وسيطًا. على الرغم من أن القضية لا تزال غير محسومة، إلا أن الزعم بأن الدول يمكن أن تستند إلى حق الدفاع عن النفس لتبرير الهجمات العسكرية ضد الأطراف الفاعلة غير الحكومية متأصل جزئيًا في ممارسات الدول الاستعمارية الأوروبية. على سبيل المثال قضية كارولين عام 1837، عندما قام المتمردون الكنديون بشن هجمات ضد الحكم الاستعماري البريطاني، وهربوا من كندا ولجأوا إلى الولايات المتحدة. طاردت القوات البريطانية هذه المجموعة إلى داخل الأراضي الأمريكية حيث هاجمت كارولين، السفينة التي كان المتمردون وأنصارهم يستخدمونها. حيث ادعى البريطانيون أنهم كانوا يتصرفون تحت سياق الدفاع عن النفس، وذلك لتبرير أفعالهم أمام الحكومة الأمريكية.
تضيف جمشيدي أنه منذ ذلك الحين، غالبًا ما يُستشهد بقضية كارولين – المنغمسة في المصالح الاستعمارية للملكة البريطانية – لتبرير الادعاء بأنه في ظروف معينة يمكن للدول مهاجمة الأطراف الفاعلة غير الحكومية المقيمة على أرض ذات سيادة أخرى. كان هذا صحيحًا بشكل خاص منذ هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001، عندما أصبح تساؤل ما إذا كانت الدول تملك حق الدفاع عن النفس ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية ملح بشكل متزايد.
وتواصل جمشيدي بالقول بأنه ومثل قضية كارولين نفسها، كان للضغط الذي أعقب 11 سبتمبر تأثير في الاعتراف بأن هذا الحق كانت له أصداء استعمارية. في حين تم وضع الرد على 11 سبتمبر على الفور في إطار الحرب والدفاع عن النفس، فإن قرار تبني مثل هذا الإطار، على حد تعبير أنتوني أنغي، يعكس وجهة النظر القائلة بأن “تهديد الإرهاب لا يمكن معالجته إلا من خلال إعادة إعمار نظام إمبراطوري جديد”. من خلال وضع هذه الحرب في إطار الدفاع عن النفس، يكون “الإرهابي”، مثله مثل “الآخر” الذي يتم استعماره، قابلا للاستبعاد من “نطاق القانون فيما يتعلق بمهاجمته، وتحريره، وهزيمته، وتحويله”، ما أدى إلى إنشاء نظام الاعتقال العسكري في خليج غوانتانامو، فضلاً عن سياسات الولايات المتحدة الأخرى لمكافحة الإرهاب.
وتتابع جمشيدي أنه حتى إذا كان هناك حق في الدفاع عن النفس ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية المتواجدة على أراضي دول تعد طرفاً ثالثاً، يمكن القول أن هذا الحق لا ينطبق، على الأقل بمعناه التقليدي، ضد الجماعات التي تخضع لسلطة احتلال الدولة التي تستند إلى هذا الحق. وعلى الرغم من أن بعض قضاتها قد خالفوا هذا الرأي، إلا أن محكمة العدل الدولية رفضت في فتواها الصادرة عام 2004، حجة إسرائيل بأنها يمكن أن تستند إلى حق الدفاع عن النفس ضد الشعب الفلسطيني. فقد قررت المحكمة، نظراً لما تملكه إسرائيل من سيطرة على الأراضي الفلسطينية وأن التهديد المزعوم لها “ينشأ من داخل تلك الأراضي وليس من خارجها”، فإن حق الدفاع عن النفس لا ينطبق.
للتوسع في هذه النظرية، تضيف جمشيدي، أوضحت الباحثة القانونية ومحامية حقوق الإنسان نورا عريقات وآخرون، أن قانون الاحتلال يتيح لقوات الاحتلال الدفاع عن نفسها من خلال استخدام سلطات الشرطة التقليدية. سلطة الشرطة هذه “مقيدة بأقل قدر من القوة اللازمة لاستعادة النظام وإخضاع العنف”. على الرغم من وجود بعض الحالات التي يمكن فيها استخدام “العنف المميت”، إلا أنه يجب أن يكون هذا “آخر ما يمكن أن يلجأ إليه من تدابير”. وبينما يتيح القانون أيضاً استخدام القوة العسكرية في ظروف استثنائية، إلا أنه ينص على “تقييدها بمصلحة السكان المدنيين السلميين“. كما تحتج عريقات، بأن استخدام إسرائيل للحق الواسع في الدفاع عن النفس قد يحمي “سلطتها الاستعمارية”، لكنه يأتي على “حساب حقوق المدنيين غير المقاتلين” بموجب قانون الاحتلال.
ترى جمشيدي أن إسرائيل حاولت وضع علاقتها بغزة ضمن نموذج حربي يسمح بمزيد من المرونة لتنفيذ هجمات عسكرية واسعة النطاق.
تلاعب إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني
تؤكد جمشيدي أنه مثالاً لفكرة إسرائيل في الدفاع عن النفس، فإن تفسير إسرائيل للقانون الدولي الإنساني له دلالات استعمارية. حيث تقول انه عندما بدأ القانون الدولي الوضعي في الظهور في القرن التاسع عشر، أصرت الدول الأوروبية على أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على “غير المتحضرين” من الملونين غير الأوروبيين وغير الغربيين؛ وبالتالي، فإنه لا يسري على حروب أوروبا واحتلالها لأراضي أجنبية. وبذلك فقد أعطى المستعمرون الأوروبيون أنفسهم تفويضًا مطلقًا لشن الحرب كما يحلو لهم ضد هذه الشعوب، وذلك من خلال وضع شعوب الجنوب العالمي خارج القانون.
وترى أنه في حين تلاشى هذا الاستبعاد الصريح لغير الغربيين من نطاق القانون خلال القرن العشرين، إلا أن بعض الدول لازالت تمارسه بأشكال أخرى، وعلى الأخص من قبل الولايات المتحدة في إطار سياسات القضاء على الإرهاب. وفي إسرائيل أيضًا، فقد وسعت الحكومة الإرث الاستعماري للقانون الدولي الإنساني من خلال إنشاء فئات قانونية جديدة وتفسير عناصر القانون الدولي الإنساني بطرق تهدف إلى منح نفسها سلطة مطلقة لاستهداف السكان الفلسطينيين.
تشير جمشيدي إلى أن هذه الأفعال تعد موضوع الكتاب الجديد للكاتب كريغ جونز، محامو الحروب: الولايات المتحدة وإسرائيل والحرب القضائية (2021)، والذي يوضح بشكل جزئي إلى أي مدى استغلت إسرائيل ومحاموها العسكريون القانون الدولي الإنساني و أعادوا كتابته كي يتناسب مع الأهداف الاستعمارية لإسرائيل. كان أول ابتكار رئيسي لإسرائيل وفقاً للكتاب هو خلق نوع جديد تمامًا من “النزاع المسلح”. فبموجب القانون الدولي الإنساني، يتم تصنيف النزاعات المسلحة إما إلى دولية أو غير دولية. إلا أنه، كما يوضح جونز، ابتكر المحامون العسكريون الإسرائيليون فئة جديدة في عام 2000 ألا وهي “النزاع المسلح دون الحرب” من أجل إطلاق العنان لجيشها لمهاجمة السكان الفلسطينيين المحتلين.
وتوضح جمشيدي أنه على الرغم من أن كتاب جونز لا يتناول السبب المنطقي الأساسي، إلا أنه تم تصميم هذه الهيكلية، تمامًا مثل جهود إسرائيل في إطار قاعدة الدفاع عن النفس، لصرف الانتباه عن قانون الاحتلال، الذي يضع قيودًا على القوة التي يمكن لإسرائيل استخدامها، ويقوم بالتأكيد على فئات القانون الدولي الإنساني الأكثر انطباقاً على النزاعات المسلحة. تدور هذه الفئات حول أربعة مبادئ أساسية: الضرورة العسكرية، والتي تحصر الهجمات بأهداف عسكرية بحتة؛ والتمييز، الذي يسمح فقط باستهداف المقاتلين والأعيان العسكرية بشكل مباشر ويتطلب تمييزهم عن المدنيين والأعيان المادية المدنية؛ والتناسب، الذي يحظر الهجمات التي قد تسبب خسائر غير متناسبة أو مفرطة للمدنيين أو الأعيان المدنية مقارنةً بفائدة الهجوم العسكرية؛ وأخيراً مبدأ الإنسانية، الذي يحظر أي معاناة أو إصابة أو تدمير غير ضروري لتحقيق أهداف عسكرية مشروعة.
بهدف إطلاق العنان للقوة الكاملة للجيش الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين المحتلين، اخترع المحامون العسكريون الإسرائيليون تصنيفاً قانونياً جديداً في عام 2000: “النزاع المسلح دون الحرب”.
كما يصف كتاب جونز، وفقاً لجمشيدي، فإنه في أوائل عام 2001، قام الجيش الإسرائيلي بتحويل هذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واختصارها في اختبار من ست نقاط لقتل الفلسطينيين في ظل نظامه الجديد “النزاع المسلح دون الحرب”. في ظل هذا الاختبار، يجب استيفاء عدة شروط. أولاً، يجب أن تكون الفائدة العسكرية المكتسبة من القتل متناسبة مع الخسائر المدنية المتوقعة وتدمير لوازم الحياة المدنية. ثانيًا، يسمح فقط باستهداف المقاتلين وأولئك الذين يشاركون في “الهجوم المباشر” في أعمال العنف. ثالثًا، إذا كان القبض على “إرهابي” مشتبه به أمرًا ممكنًا وليس قتله، فيجب محاولة الاعتقال أولاً. رابعاً، الالتزام بالاعتقال فقط بدلاً من القتل ينطبق على من هم تحت “السيطرة الأمنية الإسرائيلية”. خامساً، يجب على وزير الدفاع أو رئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم الموافقة قبل الهجوم المخطط له. سادساً، يجب أن تستهدف الهجمات “الإرهابيين” الذين يخططون للقيام بأعمال عنف في “المستقبل القريب”. في عام 2006، حددت المحكمة الإسرائيلية العليا – وهي الهيئة القضائية العليا في إسرائيل – اختبارها الخاص لعمليات القتل خارج نطاق القانون التي يرتكبها الجيش، وتبنت هذه الشروط على نطاق واسع.
تتابع جمشيدي أنه للوهلة الأولى، قد يعتقد المرء أن هذا الإطار يتوافق مع التزامات إسرائيل بموجب قانون الاحتلال؛ فهو يبدو أنه يجمع بين المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والتزام حقوق الإنسان بالاعتماد أولاً وقبل كل شيء على السلطة الشرطية المدنية. لكن بسبب ادعاء إسرائيل أنها لا تحتل غزة و أنها لا تسيطر فعليًا على القطاع، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأعراف القوة الشرطية على الإطلاق. كما يوضح كتاب جونز، فإن الرؤية الإسرائيلية تنطوي أيضًا على عدد من المشكلات الأخرى بموجب قوانين الحرب، ومنها تبني تعريف واسع جدًا لما يعنيه العنف المخطط له في “المستقبل القريب” (وهي نقطة أشارت إليها عريقات أيضًا).
وتضيف أنه قد يكون الجانب الأكثر إشكالية في سياسة القتل خارج نطاق القضاء الإسرائيلية يكمن في تعريفها ل “المتورطين المباشرين”، فضلاً عن وجهات نظرها الفضفاضة حول من يعتبر مقاتلاً في غزة. كما يوضح جونز، أنه من وجهة نظر إسرائيل، فإن “المتورطين المباشرين” لا يشملون القادة وجنود المشاة والمقاتلين فقط، بل أيضًا أي شخص يقدم “الدعم” لهؤلاء الأفراد كنتيجة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية لعام 2006. كما يشير جونز، أنه يمكن أن يشمل هذا الدعم مجموعة من الأنشطة والممارسات، تشمل أفعالاً تتراوح من قيادة مركبة لسياسيي حماس إلى تقديم “الدعم السياسي أو الديني” للجماعات التي تصنفها إسرائيل على أنها أطراف معادية.
توضح جمشيدي أن قواعد الاشتباك الإسرائيلية، التي تسترشد أساساً بقواعد القانون الدولي الإنساني ولكنها توفر إرشادات أكثر تحديدًا للقادة والجنود، تتوسع في مسألة متى يمكن استخدام القوة، كما تعزز نهجها الموسع لتصنيف المقاتلين. في عام 2015، تتابع، أصدرت منظمة “كسر الصمت”، المؤلفة من جنود إسرائيليين متقاعدين وآخرين في الخدمة الفعلية، اتفقوا على كشف جرائم إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقريرًا يعرض تفاصيل قواعد الاشتباك للهجوم الإسرائيلي الكبير على غزة في عام 2014. ووفقًا لذلك التقرير، فإن الجنود الإسرائيليين “قالوا إن القادة طلبوا منهم النظر إلى جميع الفلسطينيين في مناطق القتال على أنهم تهديد محتمل، سواء حملوا السلاح أم لا. وأن الأفراد الذين تم رصدهم في النوافذ وأسطح المنازل – خاصة إذا كانوا يتحدثون على الهواتف المحمولة – غالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم كشافة وناشطين ويمكن إطلاق النار عليهم”.
ترى جمشيدي أنه ربما يكون هذا التعريف الواسع للمقاتلين هو المثال الأكثر وضوحًا لموقف إسرائيل تجاه القانون الدولي الإنساني واتفاقه مع السياسات الاستعمارية. وتضيف، يأتي هذا في إطار ما يلاحظه فريديريك مايجريت: “يمكن الادعاء في هذه المرحلة أن التمييز الذي تم إلغاؤه على مستوى القواعد التشغيلية الحاكمة للحرب يتسلل مرة أخرى ويضع نفسه في قلب قوانين الحرب. ويتحول من السؤال عن “كيف يجب أن يتعامل المرء مع “الهمجيين “في الحرب؟” إلى “من هو المقاتل؟” (والإجابة الضمنية .. .. ليس “همجياً”).”
وتتابع أن إسرائيل، وكجزء من سياستها الاستعمارية الموسعة لتشمل كل مقاتل أو غير مقاتل، قامت بتعريف الحياة الفلسطينية ذاتها على أنها تهديد محتمل. هذه السياسة متأصلة في الأيديولوجية الصهيونية التي تعامل الفلسطينيين على أنهم تهديد ديموغرافي لوجود إسرائيل كدولة يهودية، وقد تم تفعيلها من خلال جهود الحكومة الإسرائيلية طويلة المدى لجعل الهوية الفلسطينية مرادفة للإرهاب – وهي بطريقة أخرى، أساسية في اختبار إسرائيل المؤلف من النقاط الست أعلاه.
كان هدف إسرائيل في إعادة توجيه الإرهاب لاستخدامه لنزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية ضد العنف والاستعمار والاحتلال الإسرائيلي
تقول جمشيدي أنه منذ أوائل السبعينيات على الأقل، عملت إسرائيل جاهدة لتحويل “الإرهاب” من مصطلح وصفي محايد لنوع معين من المخططات العنيفة إلى سلاح خطابي مشبع معياريًا ومرادف للعنف غير المقبول والتدمير الوجودي. كما صرح العديد من الفقهاء، كان هدف إسرائيل في إعادة توجيه الإرهاب لاستخدامه لنزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية ضد العنف والاستعمار والاحتلال الإسرائيلي. لقد أصبحت هذه الحملة التي تختص بنزع الشرعية، تشمل جميع أشكال المقاومة الفلسطينية السلمية ومناصرة حقوق الإنسان الفلسطيني. على سبيل المثال، نص تقرير صدر في فبراير 2019، عن وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة الإسرائيلية، على أن الدعوة الفلسطينية السلمية ترقى إلى مستوى الإرهاب في حلة جديدة. يشير التقرير إلى أن:
“المنظمات الإرهابية ترى النضال المدني ضد إسرائيل والذي يتضمن المظاهرات والمسيرات وجمع التبرعات والضغط السياسي وما يسمى “بأسطول السلام”، على أنه جهد مكمل لهجماتهم المسلحة ضد دولة إسرائيل.”
وتضيف أنه بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، ليست المقاومة الفلسطينية المسلحة أو السلمية فقط هي التي تمثل شكلاً من أشكال الإرهاب؛ بل إن المصطلح يرتبط أيضاً بالحياة الفلسطينية نفسها كما تطلق عليه مايا مكداشي “البنية التحتية المدنية للإرهاب”. حيث تكتب مكداشي:
“لست مضطرًا إلى حمل سلاح في فلسطين لكي تكون ثوريًا أو “عدوًا” لإسرائيل. ليس عليك الاحتجاج أو إلقاء الحجارة أو رفع الأعلام لتشكل خطراً أو تهديداً. كما ليس عليك الاعتماد على الأنفاق تحت الأرض للحصول على الغذاء وأدوية السرطان حتى يتم اعتبارك جزءًا من البنية التحتية المدنية للإرهاب. من السهل أن تمثل تهديدًا لإسرائيل: عليك فقط أن تكون فلسطينيًا.”
تشير جمشيدي إلى أن الأعداد الكبيرة غير المتناسبة للمدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا في هجمات إسرائيل والمجازر الدموية على غزة هي الانعكاس الحقيقي لهذه السياسات. حيث بلغ عدد القتلى عام 2008، 759 مدنياً من أصل 1,391 قتيلاً فلسطينياً في غزة. وبلغ العدد في عام 2012، 87 مدنيا من أصل 167؛ وفي عام 2014 ، بلغ عدد المدنيين 1,462 من أصل 2,104. على نقيض ذلك، في عام 2008 قُتل 3 مدنيين إسرائيليين فقط. في عام 2012، قُتل 4 فقط؛ وفي عام 2014 قُتل 7.
وفقاً لجمشيدي تعد أهمية هذه الحقائق واضحة؛ حيث أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سكان غزة هي جزء لا يتجزأ من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والتطهير العرقي. وحيث تتبع الحكومة الإسرائيلية نهجاً يرى أن جميع الفلسطينيين وخاصًة في غزة، يمثلون تهديدًا محتملاً أو تهديداً فعلياً لإسرائيل. وهو نهج قائم على أساس دونية الحياة الفلسطينية وتقليل قيمتها. ويتم كل ذلك من خلال استخدامات وإساءة استخدام سلطة القانون في إضفاء الشرعية. فمن غير المقبول لأصحاب الضمير، إنكار هذه الحقائق أو تجاهلها – خاصًة في الولايات المتحدة، حيث غذت أموال الأشخاص الذين يقومون بدفع الضرائب وممارسة الدبلوماسية الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وحمتهم من المساءلة لعقود. كوننا أميركيين، تقول جمشيدي، يلقي على عاتقنا مسؤولية محاسبة تواطئنا.
** لا تتحمل القانون من أجل فلسطين أية مسؤولية عن محتوى المقالات المنشورة في موقعها. تعبر المقالات عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المنظمة. تتعهد القانون من أجل فلسطين بإتاحة المجال، دائما، لكل الكتّاب ولتبادل وجهات النظر وإثراء النقاش من كافة الأطراف على قاعدة الاحترام المتبادل.
كيف تسخر إسرائيل القانون الدولي